علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)

كسـاء الكلمـات
هكذا تمثل الأيديولوجيا لازمة تكوينية للسياسة. ومن دونها لا وجود لفكرة تريد أن تشق سبيلها إلى الفعالية لتصبح جسداً مكتمل الوجود. وقد تكون هذه الرؤية هي التي حدت بعالم الأنتربولوجيا المعروف كلايفور جيرتس إلى وصف الأيديولوجيا بأنها الخارطة الفكرية للكون. أي الكيفية التي نرى إلى الكون من خلالها. أما الحاجات السياسية فليست معطى موضوعياً مجرداً وإنما هي معطى منفرداً، متشخصاً تحكمه قيم ومصالح وعصبيات. ربما هذا هو الشيء الذي دعا آخر فلاسفة الحداثةفي الغرب فريدرك نيتشه إلى وجوب نقل كل المشكلات إلى الشعور وصولاً إلى الشغف. كشرط ضروري – كما يُفهم من كلامه – لكشف الحقيقة من دون مواربة وخداع.
وسنرى، حالئذٍ، كيف سعت الأيديولوجيا لتسمو فوق التنميط والتجزئة والحصر. قصدها في ذلك أن تحل في الميادين الفعالة، وتتلبس كل فكرة طموحة فتحيلها إلى أمر واقع. وبهذا ستظل على شموليتها ورغبتها في السيطرة. وإذا لم يتسن لها أن تسمو على كل شيء في يوم من الأيام فقد تلجأ إلى المساومة والمهادنة وفي قلبها شعور عارم بالمهانة. هذه الآلية تنطبق على شبكة التناقضات داخل مجتمع بعينه وبين مجموع البيئات والجماعات المحكومة بمصالحها وأهوائها وشروط استمرارها. وحين تذوي ظاهرة أيديولوجية في مكان ما ولظروف معينة فلا يعني هذا أن حقيقتها الوجودية هي التي ذوت واندثرت وإنما الجهاز الأيديولوجي الخاص بالظاهرة. أي بشرط انوجاد ذاك الجهاز أخذ الحادث السياسي والتاريخي لونَهُ المخصوص.
فقد تموت أيديولوجية ظاهرة سياسية بموت الأخيرة أو اضمحلالها، سواء تعلق الحادث بدولة أو جماعة أو طبقة اجتماع – سياسية. فالحاصل هو أن ما اضمحل وذوى هو مادة الظاهرة حصراً، لا قابلياتها التي لا تفتأ أن تولد من جديد سواء في المكان نفسه على يد أناس جدد أو في مكان آخر وزمان آخر، لتؤسس لانبثاق جديد في ظاهرة أخرى. إن هذا النمو المتجدد مقدر له أن يعبر السيرورة نفسها التي حكمت الولادة والنمو والكمال صعوداً ثم الاضمحلال والموت نزولاً. لكن الظاهرة الأيديولوجية التي تنفجر بعد أن تكمل دورة حياة مقدرة تبعاً لظروفها الواقعية، تموت ويبقى ذاك الذي حفزها على الولادة فإنه يمكث في القاع العميق للضمير البشري. ففي هذا المعنى يكون فناء الظاهرة فناءً سياسياً وليس فناء وجودياً. أي أن الأيديولوجيا التي غطت سيادة الظاهرة ردحاً من الوقت، لم تغب لحظة عن تغطية ظواهر أخرى وإن جهرت بخطاب مختلف وكلمات أشد قرباً إلى البراءة والعدالة وسعادة الفرد.
في الممارسة السياسية يكون على الأيديولوجيا أن تتوسل كل كلام جذاب لتهيمن وتسود وتتسلط وهي تدعو المحكومين أو من هم في الطبقات الدنيا للإيمان المحموم بالقيم والشعائر التي تفسر وتبرر خضوعهم. ومن وجه آخر فإن ثمة ما يشبه التبادل الأيديولوجي بين المهيمِن والمهيمَن عليه. كل فريق يختزن في داخله أيديولوجيا تطابق غايته في السيادة أو في الانقلاب على من له السيادة عليه. ربما بسبب هذا اللبس البليغ في مدارج استعمال الأيديولوجيا في الحقل السياسي راح عالم الإجتماع الأميركي جيمس سكوت يؤول الهيمنة الأيديولوجية بأنها تحصل عندما يوجد احتمال أن يتمكن عدد لا بأس به من الخاضعين من شغل مواقع في السلطة. أو عندما يظن المرء أنه سيتمكن ذات يوم من ممارسة فعل السيطرة الذي يتحمله اليوم. فهذا يعتبر حافزاً باطنياً يخدم في إضفاء المشروعية على أنماط الهيمنة. إنه يشجع على الصبر والرغبة في المحاكاة، كما أنه، أخيراً وليس آخراً، يعد بنوع من الثأر، حتى لو كان هذا الثأر سوف يمارس على طرف لم يكن هو في البداية موضوع الكراهية.
إن هذا ما يساعد على تفسير السبب الذي يجعل العديد من الأنظمة المسيطرة التي عاشت ردحاً طويلاً من الزمن قادرة على أن يكون لها مثل هذه الديمومة، إن الصغير الذي يستغل من قبل الكبار سوف يقيض له أن يحصل على فرصته حتى يصبح كبيراً بدوره. أما أولئك الذين يقومون بأشغال منحطَّة لصالح الآخرين في مؤسسة ما، فسوف يكون من شأنهم أن يجعلوا آخرين يقومون بتلك الأشغال لصالحهم إن قيض لهم أن يتوقعوا الإرتقاء في عملهم إلى درجة أعلى…[1] هكذا تأخذ الأيديولوجيا منحنىً تبادلياً بين الحاكم والمحكوم ثم لتتمظهر في كل محل بخطاب مناسب.
لنرَ أولاً كيف يبدو أثر الخطاب الأيديولوجي التبادلي:
يُظن أحياناً أن الخطاب الأيديولوجي العلني يكف عن فعله بمجرد بلوغه دوائر المتلقيِّن من التابعين أو الخصوم. غير أن الآثار الناجمة من عمليات الإرسال لا تفتأ أن ترتد على المرسل عبر تمثُّله لروح الخطاب نفسه. فتلك الحركة الارتدادية لأصداء الخطاب على مرسله ليست مجرد عودة سلبية لعمليات الإرسال، بقدر ما تشكل اكتمالاً موجباً لديالكتيك إنتاج الخطاب الأيديولوجي. ليست ثمة انفصال بين حدَّي العلاقة التي يتألف منها الخطاب. فما دامت الاستجابة حاصلة عبر العلاقة اللغوية الناشئة بين الحاكم والمحكوم فإن الخطاب يكف عن أن يكون أحادياً، ليُمسي خطاباً واحداً في نطاق جدلية الذهاب والإياب بين المرسِل والمرسَل إليه.
كيف تحصل هذه الجدلية؟
تستأنف الحكاية دورتها انطلاقاً من الخطاب العلني الذي هو الصورة الذاتية لمرسل الخطاب على حد وصف عالم الاجتماع الأميركي جيمس سكوت. هذه الصورة الذاتية التي ترسمها النخب المسيطرة لنفسها هي ذات مهمة محددة. وتقوم على الرغبة في أن تكون هذه هي الصورة التي تُرى بها. وبالنظر إلى قدرة النخب المسيطرة، في العادة، على إجبار الآخرين على أداء ما تريد منهم أن يؤدوه، فإن من الواضح أن خطاب الأداء العلني هو خطاب غير متساوق. ففيما نجد أنه من غير المحتمل له (الخطاب) أن يكون مجرد تراكم من الأكاذيب وسوء التفسير، نرى هذا الخطاب كسردٍ شديد التحيُّز والاجتزاء. لقد صيغ وأُريد منه أن يكون مؤثراً، وأن يؤكد على قوة النخب المسيطرة ويعطيها سمة طبيعية، وأن يغطي على قذارة غسيل حكم هذه النخب أو يقلل من شأن تلك القذارة.[2]
يوجد في الخطاب الأيديولوجي التبادلي بين الحاكمين والمحكومين منطقة اشتراك تقوم على ازدواجية الشعور بالأمان والخشية في آن. يتأتى هذا الشعور من حقيقة وجودية محيِّرة ومثيرة للهلع. حقيقة أن القويّ قويٌ إلى حين، وأن الضعيفَ ضعيفٌ إلى حين. وعلى الرغم من أن الإقرار بهذه الحقيقة خصوصاً من جانب الحاكم أمر غير وارد في خطابه العلني، إلا أنها -أي الحقيقة - تظل سارية على اليقين في قرارة نفسه. ولكن غالباً ما يجري طمسها بطقس رتيب من الكلمات، وذلك للإيحاء بديمومة البقاء على ذرى القوة والاقتدار.
كذلك هو الحال بالنسبة للمحكوم. فإنه حتى لو لم يكن يملك القدرة على الجهر بما يرتبه عليه الاعتقاد بنسبية ضعفه، أو نسبية قوة الحاكم، يبقى يملك الحيلة لإجراء مقاومة ما. قد تبتدئ المقاومة بالصمت. ولكن الصمت الماكر المنطوي على وعد مكنون بيوم يأخذ فيه خصيمه اللدود على حين بغتة منه. إنها أيديولوجيا الصمت، التي لا تفتأ إثر صبر مؤجل حتى يصدح صوتها كزلزال يهدم سلطان الخشية.
هنا تظهر جدلية التبادل على أتمِّها. فإن كلاً من المحكوم والحاكم يروح يبتني مقاومته بكلمات تعلن الموت الرمزي لخصيمه. كأنما قدر الأيديولوجيا أن تلتجئ إلى هذا النوع من الكلمات كلما آنت لحظة مواجهة. إن كل نص يرنو إلى الهيمنة يحمل بذرة أيديولوجية ما. فالرغبة في الهيمنة تبتدئ من فكرة الهيمنة. وحين يسعى أصحابها إلى حملها على محمل الجد والمرارة فإنما يقصدون في ذلك جذب الهِمَمِ والعصبيات لكي تصبح عاملاً مكوناً لفعالية كل ظاهرة سياسية أو ثقافية أو سوسيولوجية. لكن في اللحظة التي تكف فيها رغبة الهيمنة عن مجرد كونها فكرة تكون قد غدت جسماً يتحرك وينمو في الاجتماع العام. وإثر إذٍ يروح هذا الميلاد الجديد ليبتدئ رحلة جديدة بوصفه سلطة، فيما تحتاج هذه بدورها إلى رداء أيديولوجي يضمن سيادتها ويؤمن لها سيرورة بقائها واستمرارها أطول أمد ممكن.
ليس ثمة منطقة محايدة على طول مساحة الأيديولوجيا. أي أن الفاعل السياسي الاجتماعي وهو يسبح في نهر الأيديولوجيا إنما يتحد بمجرى الماء، فلا يعود يملك إلاّ أن يتَّبع قوانين المجرى وجاذبية النهر. لذلك كان الكلام عن شخص غير متورط في اللعبة الاجتماعية يعدُّ ضرباً من المستحيل. لا مناص إذا من حلول الفكرة في قلب المصلحة لكي تستوي على نشأة التخاصم الأبدي بين الحاكم والمحكوم.
إنَّ فكرة الهيمنة وهي تنتقل من حال إلى حال، تبقى تحافظ على عصبها البدئي. فهو الذي يحملها لكي تحفر سبيلها نحو الانبعاث من جديد. وهو الذي يجعل للكلمات التي يصوغها الفاعل بإتقان ويبثها إلى السامعين، قدرة عجيبة على التمثيل والتحويل والتوليد المتواصل. من الواضح، كما يقول “مور” في كتابه (اللاعدالة In- justice) إن أي فريق حاكم ينتهي به الأمر إلى جعل نفسه ضعيفاً أمام أي خط من خطوط النقد، فيما هو يحاول أن يبرر مبادئ التفاوت الإجتماعي التي يؤسس عليها حقه في السلطة.
ويبدو الوضع منطقياً إذا ما وجد الفريق المحكوم نفسه أمام هذه الصورة. فسيعمل هذا الفريق، بما أوتي من عزم لكي يصعِّد من نقده، وكشفه عما في السلطة من عيوب وخطايا. ها هنا تتدخل الشائعات بكلمات ساحرة، وجذابة إلى ميدان المواجهة. فتتحول هذه بدورها إلى سلطة جبارة، تختفي حيناً، وتظهر حيناً، تبعاً لشروط الأداء التي تفترضها ظروف العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. هكذا سوف يترتب على أية أيديولوجية مسيطرة ذات مزاعم هيمنة أن توفر للجماعات المحكومة أسلحة سياسية يفيد استخدامها في مجال الخطاب العلني…
وتأويل هذا النص، إن الجهود الأيديولوجية التي تبذلها النخب الحاكمة، إنما هي موجهة شطر إقناع المحكومين بأن خضوعهم لسلطانها هو أمر عادل. بهذا تتحول نتيجة عمليات الإقناع إلى أيديولوجيا معاكسة، هي في الحقيقة وليدة أيديولوجيا سلطة النخب الحاكمة. وعند هذه النقطة، أي عندما تحقِّق هذه الأخيرة مثل هذه التحولات سيتاح لها فسحة أكبر وأوسع لإنجاز المزيد من الاستيلاء والاستحواذ. لقد أصبح بين يديها الآن سلطتان متحدتان، متضافرتان، سوف تنتجان في المطاف الأخير شرعية التصرف بقيم ومصالح المحكومين من دون أن يستنفر هؤلاء احتجاجاً واعتراضاً على حق سلب منهم. غير أن النخب الحاكمة التي استأثرت بإذعان المحكومين واستسلامهم، لن تكتفي على ما يبدو بما بين يديها. ستذهب إلى خطاب من نوع جيد. وهو استتباع (ظاهرة اعتقاد المحكومين بأن خضوعهم أمر عادل)، بظاهرة جديدة تقوم على خلق إيمان راسخ لدى هؤلاء بأن حصول أصحاب الامتيازات على الثروة هو أمر عادل أيضاً.
إن هذه الظاهرة الشاملة، متجذرة عميقاً في عدد من الأنماط السيكولوجية على ما بيَّن جيمس سكوت، “فحين يقارن رجل سعيد وضعيته بوضعية إنسان تعيس، لا يبدو مسروراً بواقع أنه سعيد، بل نراه يرغب في أكثر من هذا… يرغب في الحصول على الحق في أن يكون سعيداً، وعلى الإعتقاد الراسخ بأنه إنما اكتسب ثروته، بالتناقض مع الإنسان الذي لم يحصل على أية ثروة، والذي كان عليه بدوره أن يكتسب تعاسته”. ثم يمضي إلى القول: إن ما تطلبه طبقة أصحاب الإمتيازات من الدين، مثلاً – إن كانت تطلب منه أي شيء على الإطلاق – إنما هو هذه الطمأنينة السيكولوجية لمشروعية حصولها على امتيازاتها[3].
على أن الرغبة السلطوية في الحصول على طوباوية جماهيرية تمنحها شرعية الحصول على الثروة والامتيازات من دون أسئلة، وعلامات استفهام مضمرة أو معلنة، إنما هي الرغبة المتأمَّلة لدى الحاكمين. لذلك فهم لا يكفّون عن المثابرة من أجل صناعة وإتقان النص الذي سيمكنهم من ذلك. وهو في هذه الحالة نص جذاب من الدرجة العليا. نص ميتافيزيقي لا يدانيه نص أرضي ويكون له مفعول السحر المنطوي على سر لا يفقه تأويله سوى صاحب السلطة نفسه. وغالباً ما يكون النص الميتافيزيقي نصاً دينياً تسليمياً لا يقبل الجدال أو السجال أو السؤال. فهذا سيمكن السلطة من ضبط سيرورة تحكُّمها بالواقع المحكوم على صورة مطلقة.
يستوي الخطاب الأيديولوجي في حيِّز كونه سلطة، أو بما هو نحو من الكلمات ترنو لتصير سلطة، على صفة المنع والحجب؛ وعلى إقامة الحد على كل مقابل مختلف. فللخطاب الأيديولوجي بهذه الصفة منطق داخلي، أكثر حالات بروزه وانكشافه تكون في الاجتماع السياسي؛ حيث يتمأسس كل شيء في هذا الاجتماع على نظام السُلَط وتحيُّزات الجماعة. يقوم الخطاب الأيديولوجي بتبرير قيُّومية الجماعة على أفرادها أو جماعة على الجماعات الأخرى. أما الفرد فلا وجود له في لغة ذلك الخطاب، أو بصفة كونه فرداً ذاوياً في نظام الجماعة. يقول إميل شارتييه (Emile Chartier) أحد أكبر أساتذة الفلسفة في فرنسا في خلال النصف الأول من القرن المنصرم “يفكر الإنسان دائماً في وحدته وصمته أمام الأسياد. وبمجرد أن يفكر الناس جماعياً حتى تسوء الأمور بسرعة. يضيف: ”ليس أعدى عند الفيلسوف من سياسة المجتمع. فسياسة الفيلسوف هي سياسة الفرد. ذلك أن المجتمع -عند شارتييه- الذي اتخذ له اسماً مستعاراً هو آلان (Alain) – هو دائماً قهر وقمع. فهو ينتج بصفة دائمة ومستمرة الحرب والعبودية والشعوذة بطبيعته الخاصة. فالإنسانية تجد نفسها دائماً في الفرد في حين تجد البربرية نفسها في المجتمع”[4].
لقد انبرت الفلسفية السياسية المعاصرة في الغرب إلى الحد الأقصى في إظهار خصومتها للخطاب الأيديولوجي. ولا سيما في تجلِّيه السياسي. ولكأن الخطاب، بحسب نظير شارتييه ومعاصره ميشيل فوكو، هو أحد المواقع الذي تمارس فيه السياسة بعض سلطتها الرهيبة بشكل أفضل. ويبدو أن الخطاب في ظاهره شيء بسيط، لكن أشكال المنع التي تلحقه تكشف باكراً وبسرعة عن ارتباطه بالرغبة بالسلطة. وما المستغرب في ذلك – يقول فوكو – ما دام الخطاب – وقد أوضح لنا التحليل النفسي ذلك – ليس فقط هو ما يظهر أو ما يخفى الرغبة، لكنه أيضاً هو موضوع الرغبة. وما دام الخطاب ليس فقط هو ما يترجم الصراعات أو أنظمة السيطرة بل هو ما نصارع من أجله، وما نصارع به، وهو السلطة التي نحاول الاستيلاء عليها.[5]
أيديولوجيا ضد أبنائها
لا شك في أن انخطاف المحكومين بسحر النص يؤدي إلى تحولهم قوة تجديد لسلطة الحاكمين. إن هذه الدينامية المفارقة ناجمة – كما يبين جيمس سكوت- من شوق الجماهير الدائم إلى البطولة المخلصة حتى لو كانت بطولة كاذبة. وناجمة كذلك من ميلها الغريزي نحو اللامعقول. وبما أن المحرضات القادرة على تهييج الجماهير متنوعة، متعددة، وبما أن الجماهير تنقاد لها دائماً، فإننا نجدها حيوية ومتحركة إلى أبعد حد. فنحن نجدها تنتقل في لحظة واحدة من مرحلة الضراوة الأكثر دموية إلى مرحلة البطولة المطلقة. إن الجمهور يمكنه بسهولة أن يصبح جلاداً، ولكن يمكنه بنفس السهولة أن يصبح ضحية وشهيداً (…) إن الانفعالات التحريضية المختلفة التي تخضع لها الجماهير – قد تكون كريمة أو مجرمة، بطولية أو جبانة، وذلك بحسب نوعية هذه المحرضات – ولكنها سوف تكون دائماً قوية ومهيمنة على نفوس الجماهير إلى درجة أن غريزة حب البقاء نفسها تزول أمامها.
تستخدم السلطة بسهولة تلك الأيديولوجيا الخفية الكامنة في نفوس المحكومين. فلهذه الأيديولوجيا المتحولة إلى إيمان راسخ، مخزون قوة قادرة على زحزحة الجبال كما يقول الإنجيل، وأما دور القادة الحاكمين فيكمن في بث الإيمان. سواء أكان هذا الإيمان دينياً أم سياسياً أم اجتماعياً.
الفاعلون الأيديولوجيون هم الذين يخلقون الإيمان بعمل ما، أو بشخص ما أو بفكرة ما. ومن بين كل القوى التي تمتلكها البشرية نجد أن الإيمان كان أهمها وأقواها. القادة يحركون الأحياز الأكثر مرونة وقبولاً وطواعية لدى الجماهير، لكن اللغة التي يستخدمونها غالباً ما تتخذ اللامعقول والمخفي والجاذب لقوى النفس، صفة لها.
وإذن، فلا مجال للحجة العقلية في هذه الزاوية الوظيفية من ساحة الأيديولوجيا. تلك التي يواصل فيها الحاكمون شحن الغرائز بنار الكلمات. وهكذا سنرى في كثير من الأحوال أن الخطيب العقلاني مثلاً أي ذلك الذي يحشد الوثائق والحجج الحسية والمقترحات، ويخطب بها العقل العام، سنراه قليل الحظ في الفوز بدعم الجمهور وتأييده، بينما نرى على العكس من ذلك، حين تنأخذ الجماهير وتتأثر وتتهيأ للحركة إذا ما جاءها متكلم لا يقول شيئاً سوى قرع الطبول والكلمات الساحرة العجيبة..[6]
لا تظل الأيديولوجيا على حال وحيدة الجانب. فما دامت حمالة وجوه، مثل كل نص قابل للتأويل، فإن استخدامها المعاكس هو على نفس الدرجة من الفعالية. فإذا كان الحاكمون يستطيعون صوغ منظومة أيديولوجية متحركة ولا متناهية بقصد ترميم تصدعهم أو تجديد حكمهم، فللمحكومين أيضاً فرصة النجاح، وعن طريق الأيديولوجيا، لإقصاء حاكميهم والإستيلاء على الحكم. لقد قال مرة فاكلاف هافل – الكاتب ورئيس جمهورية سلوفاكيا الأسبق بعد التحولات العاصفة في المعسكر الاشتراكي – “إن المجتمع حيوان غامض جداً، مكتنف بالأسرار، له وجوه وإمكانات مخيفة عديدة… ومن قصر النظر البالغ أن نعتقد أن الوجه الذي يعرضه المجتمع لك في لحظة من اللحظات، هو الوجه الصحيح الوحيد. لا أحد منا يعرف جميع الإمكانات التي تكمن نائمة في روح السكان”…
كان هافل يومئ إلى “جيولوجيا اجتماعية” لا بد أن تختلج في يوم من الأيام لتطيح بما بدا كأنه ثابت لا يشوب يقينه شيء. إن هذه “الجيولوجيا” كامنة متحفزة في ثنايا المحكومين. وعلى قواعدها سيبنون قواهم ويراكمون عدتهم وعديدهم. ويصوغون كلماتهم المناسبة كوقود ينشر النار في الهشيم. والتجارب المعيَّنة تدل، بما لا يرقى إليه الشك، على أن الجماهير لا تنقصها القدرة والنباهة على صنع كلامها وخطبائها وقيادييها. وهي إذ تستهل زمن الإعداد للثورة تأخذ مطامحها ورغباتها شكل خطاب هادر مملوء بشغف الكلمات. هذا الشغف هو الذي سيظهر على الملأ في صورة خطاب علني، ودعوة ذات صفة رسالية فوق طبيعية.
إن الخطاب والدعوة هنا، هما الأيديولوجيا المعاكسة عينها. إلا أن هذه لا تختلف عن تلك التي يصنعها الحاكمون، أو يلتجئون إليها في حالات الضرورة، إلا في التوجيه المراد لها. ربما تأخذ أيديولوجيا السلطة الحاكمة وأيديولوجيا الجماهير المحكومة اللغة نفسها والمظلة الأخلاقية نفسها، وهذا يعني، على الأكيد أن الأيديولوجيا هي مثابة لعبة حكائية يدخلها من يشاء من دون استئذان حتى ينال غايته العظمى، إن الأيديولوجيا – كما يقول تربورن – لا تخضع الناس لنظام معطى فقط، بل هي توظِّفُهم، وتهيُّؤهم أيضاً من أجل العمل الإجتماعي الواعي، بما في ذلك أفعال التغيير المتدرج أو الثوري.
إن الأيديولوجيات لا تعمل فقط كـ”أسمنت اجتماعي”. أما القصد من توصيف كهذا فيرمي إلى النظر أن المعطى الأيديولوجي لا يؤخذ للتسكين والإقناع والمخادعة فحسب، وإنما أيضاً وأساساً كمعطى للفوضى والتوتر والتشكيك والثورة. وفي اعتقاد تربورن: أنه يبدو من المناسب أكثر، ومن المثمر أكثر أن نرى الأيديولوجيات، لا كحيازات، كأفكار (مقولبة) بل كسيرورات اجتماعية. ضمن هذه السيرورات المستمرة، تتداخل الأيديولوجيات، تتنافس وتتصادم، يُسقِطُ أو يعزِّزُ بعضها بعضاً. لكن العملية الراهنة للأيديولوجيا في المجتمع المعاصر يوضحها ضجيج الأصوات والإشارات في شوارع المدن الكبرى أكثر مما يوضحها النص الواصل بصفاء إلى القارئ المعزول أو المعلم أو الشخصية التلفزيونية التي تخاطب جمهوراً منزلياً هادئاً…
إنها بكلمة، الفضاء الذي يسبح العالم الجديد في داخله من دون أن يتنفس بعد…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – جيمس سكوت ـ المقاومة بالحيلة ـ كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم؟ ـ ترجمة ابراهيم العريس ومخايل خوري ـ دار الساقي ـ بيروت ـ لندن 1995 ـ ص42
[2] – جيمس سكوت المصدر نفسه – ص 43.
[3] – جيمس سكوت ـ المصدر نفسه ـ ص501.
[4] – اتخذ اميل شارتييه اسماً مستعاراً هو آلان ( Alan ) وكتب عدداً من الكتب والمقالات الفكرية والفلسفية بهذا الإسم.
[5] – Alain: Eléments d’une doctrine radicale “3ém edit. Nrf.Gallimard – Paris. 1925 – P.
[6] – جيمس سكوت ـ المصدر نفسه ـ ص51.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
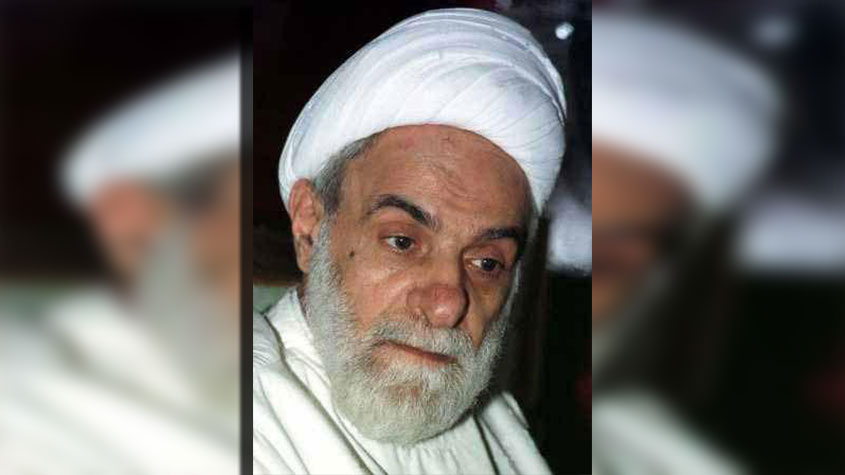 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
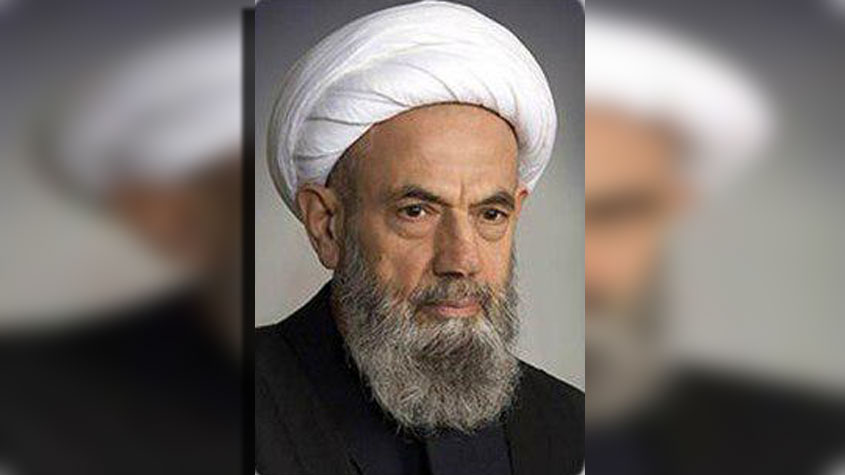 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
-
 مجلس أخلاق
مجلس أخلاق
الشيخ حسين مظاهري
-
 معنى (كتب) في القرآن الكريم
معنى (كتب) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
 ما الحيلة مع أقاويل النّاس؟
ما الحيلة مع أقاويل النّاس؟
الشيخ علي رضا بناهيان
-
 مناجاة الزاهدين(5): وَتَوَلَّ أُمُورَنَا بِحُسْنِ كِفَايَتِكَ
مناجاة الزاهدين(5): وَتَوَلَّ أُمُورَنَا بِحُسْنِ كِفَايَتِكَ
الشيخ محمد مصباح يزدي
-
 إعداد المراهقين والمراهقات قبل مرحلة البلوغ يساعدهم على تجاوز الاضطرابات النفسية المصاحبة لها
إعداد المراهقين والمراهقات قبل مرحلة البلوغ يساعدهم على تجاوز الاضطرابات النفسية المصاحبة لها
عدنان الحاجي
الشعراء
-
 أمّ البنين: ملاذ قلوب المشتاقين
أمّ البنين: ملاذ قلوب المشتاقين
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-

العدد الأربعون من مجلّة الاستغراب
-
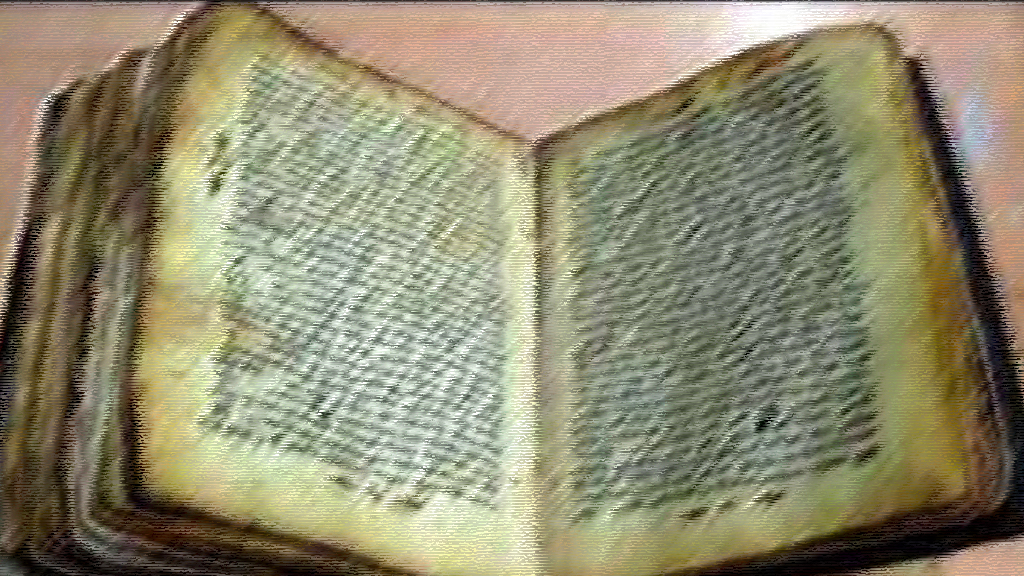
الموعظة بالتاريخ
-

كلام عن إصابة العين (1)
-

الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
-

صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
-
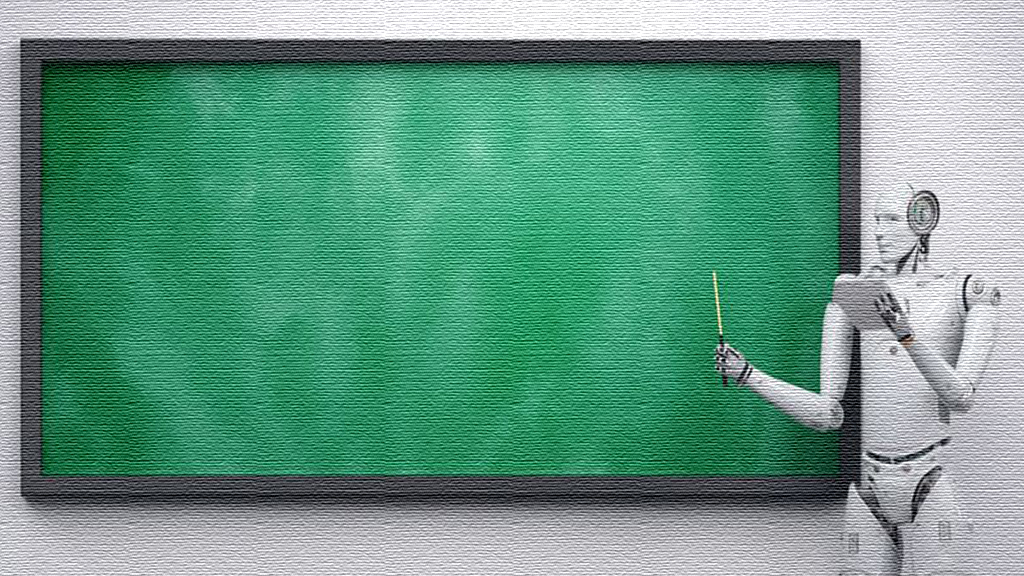
التحوّل التعليميّ في عصر الذكاء الاصطناعيّ
-
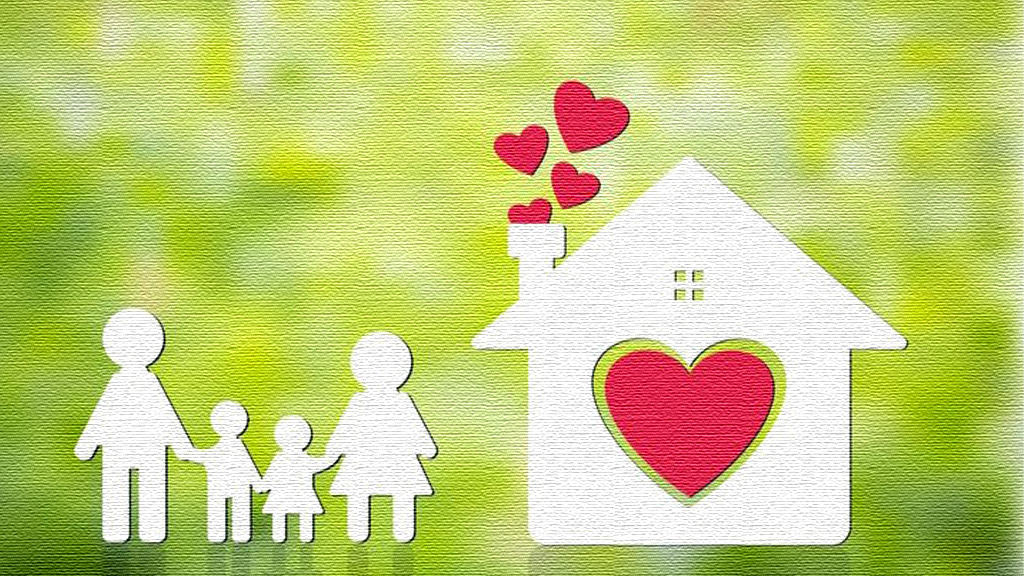
مجلس أخلاق
-

الزهراء (ع) نموذج المرأة المسلمة
-

معنى (كتب) في القرآن الكريم
-
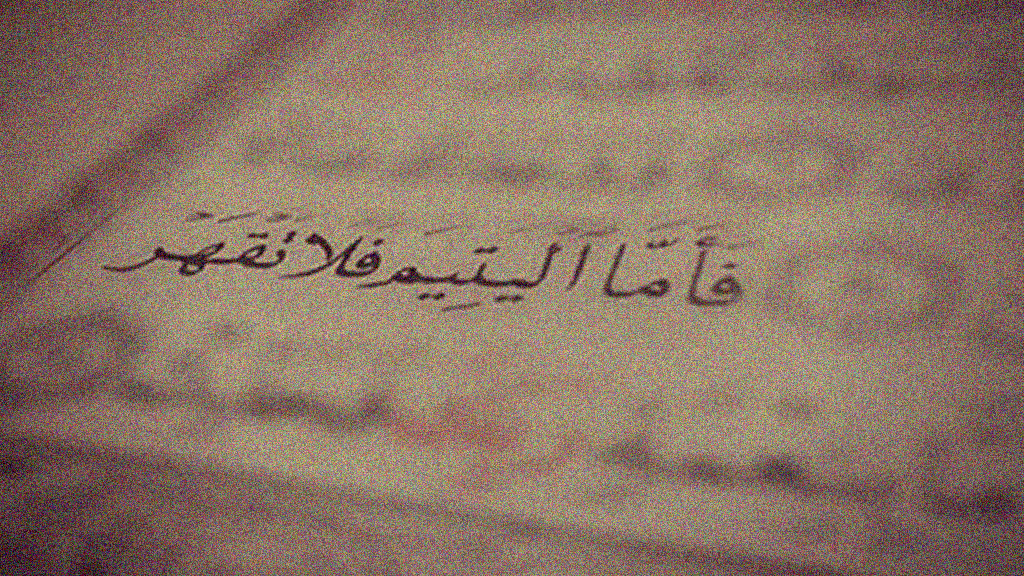
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ









