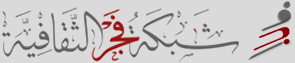علمٌ وفكر
معلومات الكاتب :
الاسم :
محمود حيدرعن الكاتب :
مفكر وباحث في الفلسفة السياسية، مدير التحرير المركزي لفصلية "الاستغراب".بالإيحاء.. كان الوجود كلّه (2)

فطرانيَّة الوحي وسرَّانيَّته
الميول الوحيانيَّة في الإنسان فطريَّة، وهي الأرض البكر التي منها تُستنبتُ المعارف الإلهيَّة وعلوم التوحيد، شأنها في هذا، شأن القبليَّات التي بها يستعينُ العقلُ على إدراك البديهيَّات. لهذا صحَّ القول أنَّ التعاليم والأحكام الوحيانيَّة جميعها مبنيَّة على العقل والفطرة، وأنَّ العمل بمقتضاهما يؤدّي إلى نموِّ وتفتُّح أسمى مراتب المعرفة لدى الإنسان. ونعني بهذه المرتبة، المعرفة الوحيانيَّة المتأتيِّة من الفطرة بوصفها غرسة إلهيَّة بَدئيَّة في الطبيعة البشريَّة. فهي راسخة في الكينونة الإنسانيَّة، ولا يمكن لفطرة كائنٍ ما أن يكون لها اقتضاء معيَّن في مرحلة زمنيَّة، بينما لها اقتضاء آخر في حقبة زمنيَّة أخرى. وبما أن الأمور الفطريَّة من اقتضاءات أصل خِلقة كلّ موجود، فإنَّها – لأجل ذلك - لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلّم، وإن احتاجت إلى التربية والتعلُّم قصدَ التوجُّه والاهتداء والثبات على الأصل. لهذا السبب ينبري أهل البحث إلى تصنيف المعرفة الفطريَّة ضمن دائرتين معرفيَّتين:
الأولى: دائرة المدركات الفطريَّة الموجودة في تكوين كلِّ إنسان ولا حاجة فيها إلى التعلُّم والاكتساب.
الثانية: دائرة الميول والرغبات الفطريَّة التي تكون بمقتضى الطبيعة التكوينيَّة لدى كلِّ فرد.
الدائرتان المذكورتان تفضيان إلى المعادلة التالية: لـمَّا ثبت أنَّ لكلِّ فرد نوعًا من معرفة الله، ولا يحتاج معه إلى التعلُّم والتعليم؛ جاز أن ندعو ذلك بـ «معرفة الله الفطريَّة».. وإذا ثبت وجود نوعٍ من الميل إلى الله وإلى عبادته في كلِّ إنسان، أمكن أن نسمّيه «عبادة الله الفطريَّة»، أو ما يسمَّى بـ «التديُّن الفطريّ». والحاصل أنَّ معرفة الله الفطريَّة تعني: أنَّ الإنسان يعرف الله بقلبه، وفي عمق كينونته تنغرس المعرفة الشعوريَّة بالتوحيد. ولأنَّ هذه القابليَّات الفطريَّة لا تغني عن التفكير والتأمُّل والاستدلال العقليّ، فإنَّ اتّساق صلات الوصل بين المعرفة الفطريَّة والمعرفة العقليَّة، يفضي إلى استشعار الوحي المعاني القصية للفعل الوحياني، بل قد يترقَّى المتلقِّي إلى تلك الدرجة التي لا تعود فيها نفسه عرضة لغزوات الشكّ.
وهذي هي على وجه التقريب ما يُعرف بـ “الحادث الروحاني” الذي يعرب عن اختبار معنويٍّ، وانخطاف روحيٍّ لا يتوفَّر عليهما إلا الذي تعرض له واستقام عليه. بعض علماء الأنثروبولوجيا (علم الإناسة) ينفون أن يكون الوحيانيُّ أو المقدَّس مجرَّد طور من أطوار الوعي البشريِّ، بل يرونه عنصرًا مكوِّنًا لبنية هذا الوعي. وأنَّ وجود العالم كله هو حصيلة لتجلِّي الوحيانيِّ وفعله.
في الحضرة الوحيانيَّة كصيرورة وعي وعيش، يُستشعرُ سرُّ الوحي بالَّلمح الباطنيِّ. وهذا السرُّ- كما طاب للفيلسوف واللَّاهوتيِّ الألمانيِّ رودولف أوتو أن يقول- هو خاطرة قَبْسيَّة تُستمدُّ من الدائرة الطبيعيَّة لوجودنا، ولكنَّها عاجزة عن أن تفصح عنه إفصاحًا تامًّا. فما هو سرِّيٌّ – كما يضيف- إنَّما هو “ذو الغيريَّة التامَّة”، ذاك الذي يوجد بتمامه خارج دائرة المعهود، وهو الذي يقع نتيجة لذلك، بالضَّبط، خلف حدود “المألوف”، ويناقضه، مالئًا الذِّهن دهشةً وذهولًا. أمَّا الكلام على “سرَّانيَّة” الوحي فهو كلامٌ يتخطَّى منطق العقل المقيَّد وتناهيه. فالأمر “السرّيُّ” من جهة كونه وَحْيًا، إنَّما يقع خارج إمساكنا به، أو إدراكنا له، وذلك عائدٌ، ليس فقط إلى أنَّ لمعرفتنا حدودًا مرسومة، وإنَّما لأنَّنا بإزاء حضورٍ لا كأيِّ حضور، ولأنَّنا أيضاً وأساساً في حضرة الذي ماهيَّته وهويَّته لا تقاسان بما لدينا من أعراف ومراسيم.
ولأنَّ الوحي حضورٌ مطويٌّ في مكنون الألوهية فإنَّ وجه الامتياز في التعرُّف عليه، هو في كونه علمًا سرَّانيًّا (من السرِّ)؛ أي أنَّه علم كامن في السريرة، ومعرفته على وجهين: إمَّا بالنظر والاستدلال، أو بالتصديق والتسليم. إلَّا أنَّه بوجهيه المذكورين يؤلِّف وحدة علميَّة، ولو تقدّم فيها الوجه العمليُّ كاختبار باطنيٍّ، على النظريِّ كتعبير لسانيٍّ لاحق عن التجربة. لهذا لا يمكن الفصل بين هذين الوجهين بحال من الأحوال.
الوحي بما هو شأن عقلانيٌّ – فؤاديّ
تُظهر تاريخيَّة الجدل الَّلاهوتيِّ واحدة من أبرز المعضلات الناجمة عن استخدام العقل القياسيِّ في إثبات الوحي. من ذلك ما واجهته تيَّارات لاهوتيَّة في الغرب حين وجدت نفسها عاجزة عن تسويغ الجانب غير العقلانيِّ في بنيتها الاعتقاديَّة. لقد بدت الصورة على غير ما كانت تبتغيه تلك التيَّارات. فإنَّها بدل أن تحتفظ بالعنصر غير العقلانيِّ حيًّا في قلب الاختبار الدينيِّ، فقد أخفقت إخفاقًا بيّنًا في تقدير قيمته، لمَّا أغدقت على فكرة الله، تفسيرًا فكريًّا وعقلانيًّا، أحادي الجانب. وكانت النتيجة من بعد ذلك، النكوص إلى دنيا المرئيات الصمَّاء والمَيْل نحو علمنة الإيمان.
حيال هذه الوضعيَّة، سينبري من النظَّار من يقارب المسألة على نحو يُرفَع فيه التناقض بين العقل والوحي. يبتدئ هؤلاء من الإقرار بحقيقة أنَّ إيمان المؤمن بالأمر الوحيانيِّ لا يمكن وصفه، أو تحديد معناه على النحو الذي تتحدَّد فيه معاني الموجودات وفق أطرها المفاهيميَّة. فالإيمان بالوحي بما هو أمرٌ غيبيٌّ، ليس مجرَّد ظاهرة تُماثِل الظاهرات الطبيعيَّة الأخرى، بل هو الظاهرة المركزيَّة في حياة الإنسان الشخصيَّة الجليَّة والخفيَّة في الوقت نفسه. ولأنَّ الإيمان إمكانيَّة جوهريَّة للإنسان، فوجوده ضروريٌّ وكلِّيّْ، وهو ممكن وضروريٌّ أيضًا في كلِّ زمان ومكان. وإذا فُهِمَ الإيمان في جوهره على أنَّه همٌّ أقصى، فلا يمكن إذّاك أن يثلمه العلم الحديث أو أيُّ نوع من الفلسفة. ومردُّ ذلك – على ما يبيِّن اللَّاهوتي والفيلسوف الألماني بول تيلش- إلى أنَّه يسوِّغ ذاته ضدَّ من يهاجمونه، لأنَّهم لا يستطيعون أن يهاجموه إلَّا باسم إيمان آخر. ولعلَّ أبرز ما في واقعيَّة الإيمان أنَّ الذين يرفضونه إنَّما يعبِّرون، وهم يفعلون ذلك، عن إيمان ما.
ينبغي القول أيضًا إنَّ المعنى الجوهريَّ لنشاط العقل في امتداداته وإنجازاته، هو ما يفيد بأنَّه غير مقيَّد بتناهيه ومحدوديَّته، بل هو على وعيٍ بهذا التناهي. وبهذا الوعي سوف يتمكَّن من مجاوزة التناهي والتقييد ليصير الإقرار بإيحاء الوحي كفعلٍ إيجاديٍّ للوجود هو نفسه المقام الذي يتوصَّل إليه العقل في أطواره الامتداديَّة. وعند هذه الوضعيَّة المتعالية يضمحلُّ التناقض المتصوَّر بين طبيعة الوحي وطبيعة العقل، ليتموضع كلٌّ منهما في داخل الآخر.
سوف نجد نظير هذه المقاربة في ما شهدته الحُقَب الإسلاميَّة الأولى من مجادلات كلاميَّة وفلسفيَّة بصدد صلات الوصل أو القطيعة بين المعرفتين العقليَّة والنقليَّة. فقد انبرى جمع من المحقّقين والعرفاء إلى إجراء تأصيل عقليٍّ للكشف والشهود في ميدان التصوُّف النظريِّ.. نذكر في هذا المنفسح ما سعى له أبو إسحاق الشاطبي (ت.790هـ) لجهة إنشاء نظريَّة فقهيَّة للتصوُّف تقوم على الموافقة بين الشرع والكشف.
يقرِّر الشاطبيُّ أنَّ الخوارق التي عبَّرت عنها كرامات الأولياء ومكاشفاتهم، هي حقيقة واقعيَّة، واستدلَّ على مذهبه بشواهد تجعل المعجزات موصولة بتاريخ الأنبياء كما تبيِّنه آيات القرآن الكريم. أمَّا المكاشفات التي تحدث للأولياء، فيضعها في منطقة النظر الشرعيّ. والحجَّة المنطقيَّة عنده أنَّ المكاشفة هي نتاج لمقدِّمات، والمقدِّمات مسبِّبات لأسباب، ولمَّا كانت الأسباب والمقدِّمات نازلة تحت نظر الشرع، فمن المنطقيِّ أن ينسحب السياق نفسه على المعجزات والخوارق والمكاشفات لأنَّها تتبع لها. وبهذا تصبح المعجزات من مشمولات الشريعة لا من أسرار الحقيقة، ولذلك جهد في جعل مسائل التصوُّف، ما جلَّ منها وما دقَّ، داخلةً في نطاق الشريعة وغير خارجة عنها بحال. فالشرع – كما يقول – حاكم على الخوارق، ولا يخرج عن حكمه شيء منها. في السياق إيَّاه يورد الحكيم الإلهيُّ صدر الدين الشيرازي في كتاب “الأسفار” خمسة أركان لتحصيل المعارف الوحيانيَّة استنادًا إلى منظومته الجامعة بين القرآن والبرهان والعرفان:
أول هذه الأركان، معرفة النفس وإزالة الحُجُب بينها وبين الحقائق العينيَّة والمعارف الحقَّة اليقينيَّة.
ثانيها، المعرفة القلبيَّة أساس معرفة النفس، فهي محلُّ التجلّي والإدراك، وهما متَّحدان، فلا معرفة من دون شهود النفس لذاتها؛ ذلك بأنَّها شعورٌ وحركةٌ داخليَّان، وتفاعل ذاتيٌّ، وأمر وجوديٌّ، والنفس حقيقة الإنسان وروحه، “فمن لا معرفة له بالنفس لا وجود لنفسه، لأنَّ وجود النفس هو عين النور والحضور والشعور”.
ثالثها، الألم والمعاناة من مفارقة الحقائق. والألم حالة إدراكيَّة شعوريَّة، يعيشها الطالب للحقِّ، ويتقلَّب فيها بحرقة وبحزن على البعد، والتفرُّق عن أصل وجوده وكينونته؛ ولا يرتفع الألم، إلَّا بإدراك ملائمٍ لمقام النفس وأحوالها. ثمَّ يعرِّف الشيرازيُّ الَّلذَّة والألم بقوله: “اللَّذة كمالٌ خاصٌّ بالمدرِكِ بما هو إدراكٌ لذلك الكمال، والألم ضدُّ كمال خاصٍّ بالمدرِكِ بما هو إدراكٌ لذلك الضدّ”. فالَّلذَّة والألم حالتان إدراكيَّتان معرفيَّتان، تحصلان للمدرِك وللعارف. وحيث إنَّ الإدراك أمرٌ وجوديٌّ، وليس عدميًّا أو اعتباريًّا، ونظرًا إلى الاتحاد بين المدرِكِ والمدْرَك، لزم من ذلك أنَّ الألم والَّلذَّة متَّحدان بالعارف وبالمدرِك. ويثبت الشيرازيُّ بالبرهان في أبحاثه أنَّ الَّلذَّة هي الإدراك بالملائم، والألم هو الإدراك بالمنافي. الألم الذي يعيشه العارف لمفارقته ما يلائمه من الإدراك والمعارف هو أمرٌ وجوديٌّ حقيقيٌّ؛ وإنَّ لسلوك منهج الشهود أصلًا متجذِّرًا في المعاناة، لا يتحقَّق بها إلَّا كلُّ عارفٍ صادق. وهكذا تترتَّب المعاناة في مراتب ودرجات بحسب نشآت النفس الإنسانيَّة.
رابعها، العشق والشوق والمحبَّة، وهي مصطلحات وردت في آثار صاحب الحكمة المتعالية، ولا تدلُّ على معنى واحد؛ وإنَّما تتفاوت بحسب النشأة الإمكانيَّة للهوّيَّات الوجوديَّة. فقد حكم الحكماء بسَرَيان محبَّة الله في جميع الموجودات حتى الجماد والنبات، بالحجَّة والبرهان، وأحكموا القول بأنَّ مبدأ جميع الحركات والسكنات في العاليات والسافلات من الفلكيَّات والأرضيَّات، هو كشف الواحد الأحد، والشوق إلى المعبود الصمد.
خامسها، التجرُّد والتعالي، ويكون ذلك عبر الرياضة والمجاهدة الروحيَّة والعلميَّة، وبشرائط مخصوصة، منها أنَّ التجرُّد عن عالم الحسِّ، هو مقدِّمة لعلوم المكاشفة، التي هي المقصد الأصليُّ والكمال الحقيقيُّ، وتتحقَّق بعد التهذيب لظاهر الإنسان وباطنه. فعالم الحسِّ مانعٌ للنور والتجلّي، وعلى السالك أن يصفِّي قلبه، ويجلِّي عنه صدأ المعاصي الحسِّيَّة والخياليَّة، التي مردُّها إلى الحسِّيات، لأنَّ القلب كالمرآة، لا ينعكس فيه الحقُّ إلَّا بعد الصقل من الشوائب. أمَّا الرياضة الحكميَّة، فهي معرفة الربوبيَّات والفنِّ الإلهيِّ المتعلِّقَين بذاته وبصفاته وبأفعاله، ومعرفة المعاد، والرُّسل، والملائكة، والوحي؛ إن الذي يوجب القرب الإلهيَّ. هو العلم الإلهيُّ وعلم المكاشفات، لا علم المعاملات.
تعليقات الزوار
الكتاب
-
 حقيقة التوكل على الله
حقيقة التوكل على الله
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
-
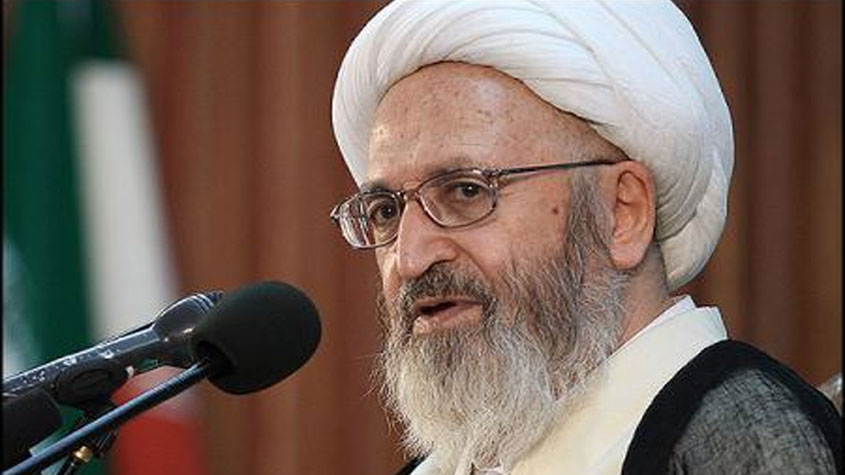 من عجائب التنبؤات القرآنية
من عجائب التنبؤات القرآنية
الشيخ جعفر السبحاني
-
 تسبيحة السيدة الزهراء (ع)
تسبيحة السيدة الزهراء (ع)
الشيخ شفيق جرادي
-
 المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)
المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)
إيمان شمس الدين
-
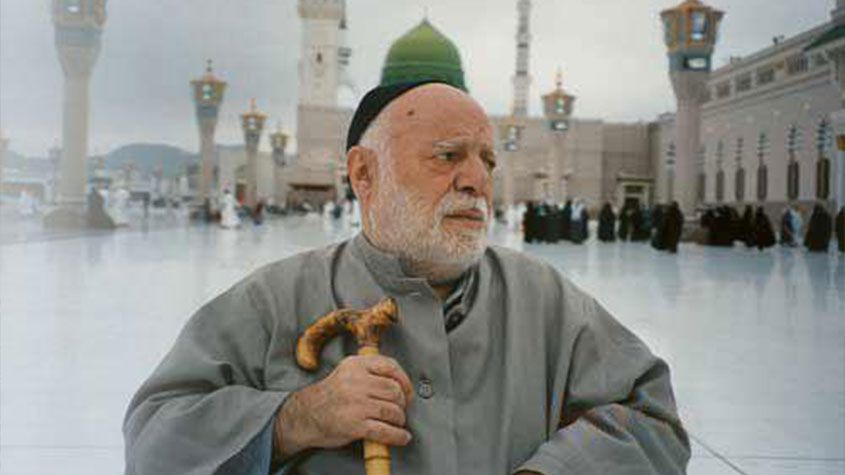 معنى (عول) في القرآن الكريم
معنى (عول) في القرآن الكريم
الشيخ حسن المصطفوي
-
 (التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
(التّردّد) مشكلة التسويف، تكنولوجيا جديدة تساعد في التغلّب عليها
عدنان الحاجي
-
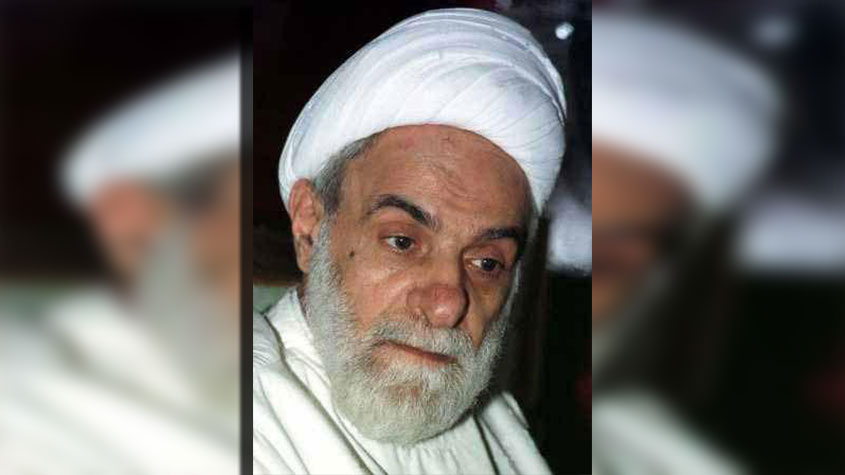 الموعظة بالتاريخ
الموعظة بالتاريخ
الشيخ محمد مهدي شمس الدين
-
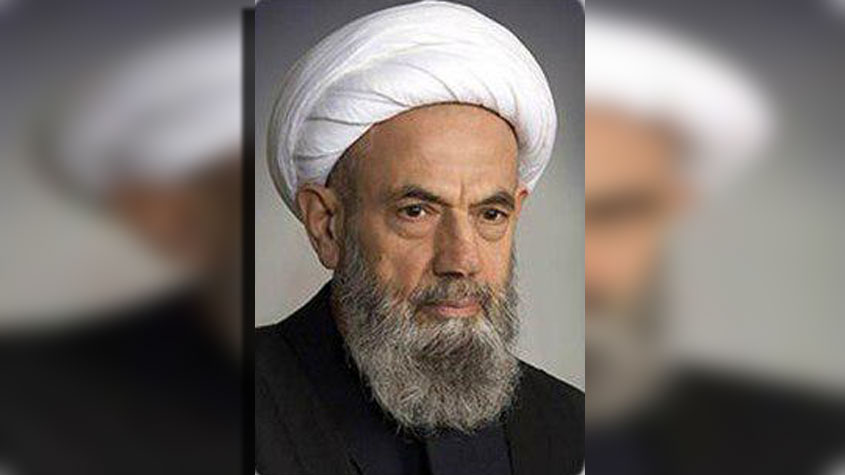 كلام عن إصابة العين (1)
كلام عن إصابة العين (1)
الشيخ محمد هادي معرفة
-
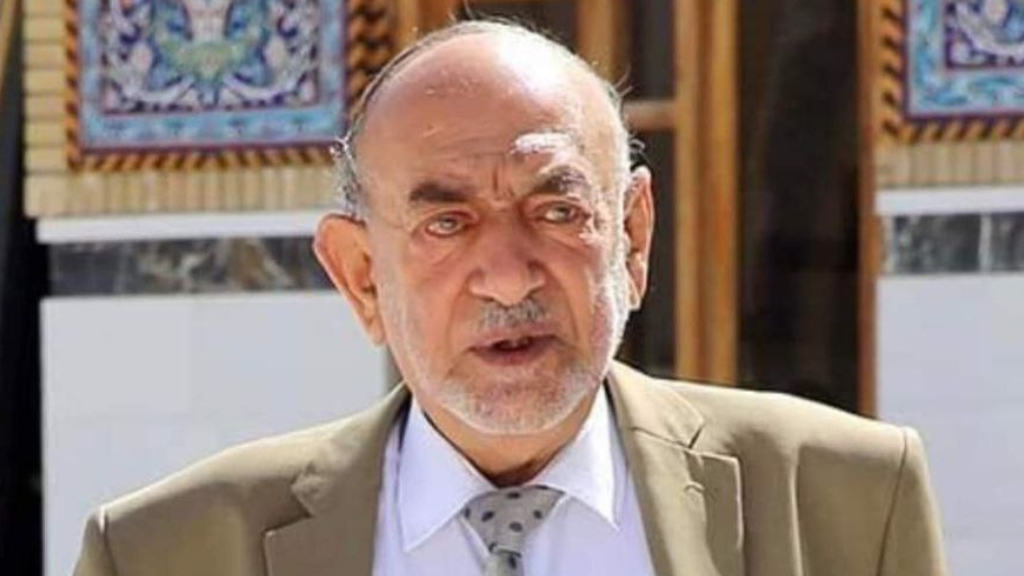 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدلالة الصوتية في القرآن الكريم (1)
الدكتور محمد حسين علي الصغير
-
 صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
صفات الأيديولوجي؛ معاينة لرحلة الفاعل في ممارسة الأفكار (7)
محمود حيدر
الشعراء
-
 السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
السيّدة الزهراء: صلوات سدرة المنتهى
حسين حسن آل جامع
-
 الصّاعدون كثيرًا
الصّاعدون كثيرًا
حبيب المعاتيق
-
 أيقونة في ذرى العرش
أيقونة في ذرى العرش
فريد عبد الله النمر
-
 سأحمل للإنسان لهفته
سأحمل للإنسان لهفته
عبدالله طاهر المعيبد
-
 خارطةُ الحَنين
خارطةُ الحَنين
ناجي حرابة
-
 هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
هدهدة الأمّ في أذن الزّلزال
أحمد الرويعي
-
 وقف الزّمان
وقف الزّمان
حسين آل سهوان
-
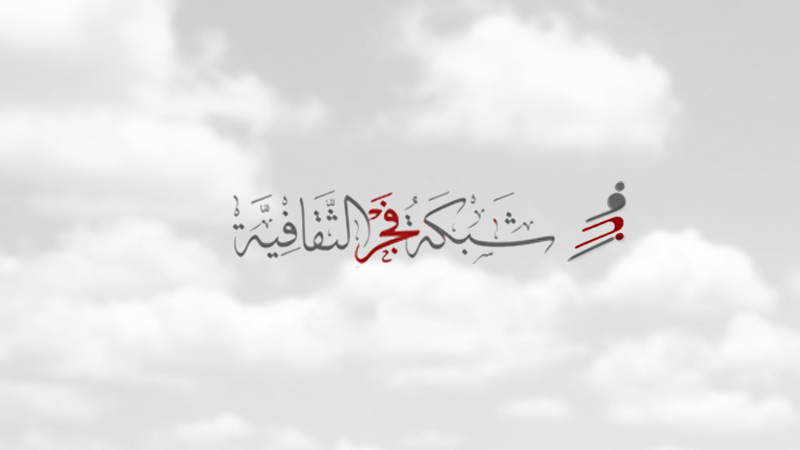 سجود القيد في محراب العشق
سجود القيد في محراب العشق
أسمهان آل تراب
-
 رَجْعٌ على جدار القصر
رَجْعٌ على جدار القصر
أحمد الماجد
-
 خذني
خذني
علي النمر
آخر المواضيع
-
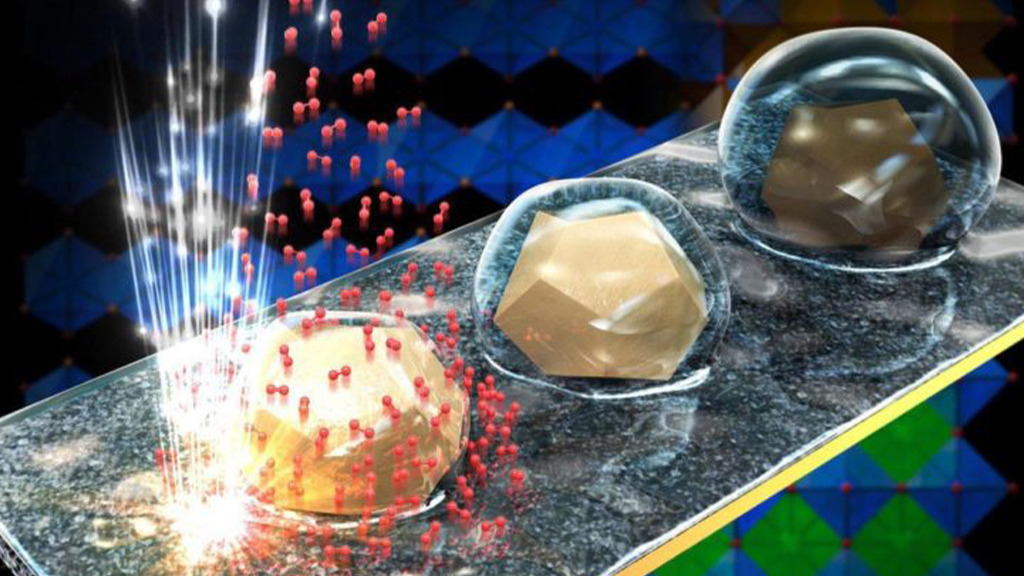
محفّز جديد وغير مكلف يسرّع إنتاج الأوكسجين من الماء
-
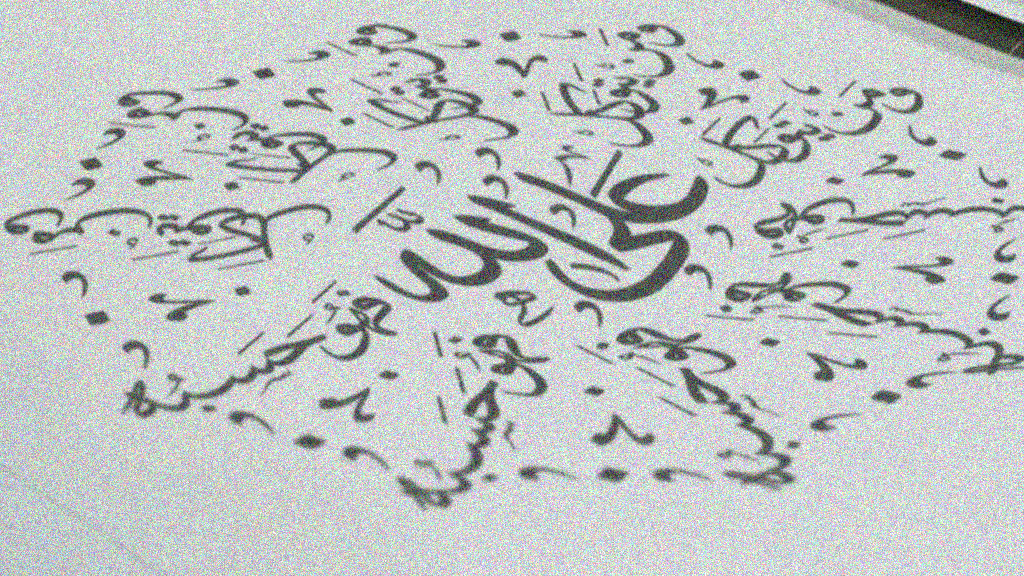
حقيقة التوكل على الله
-
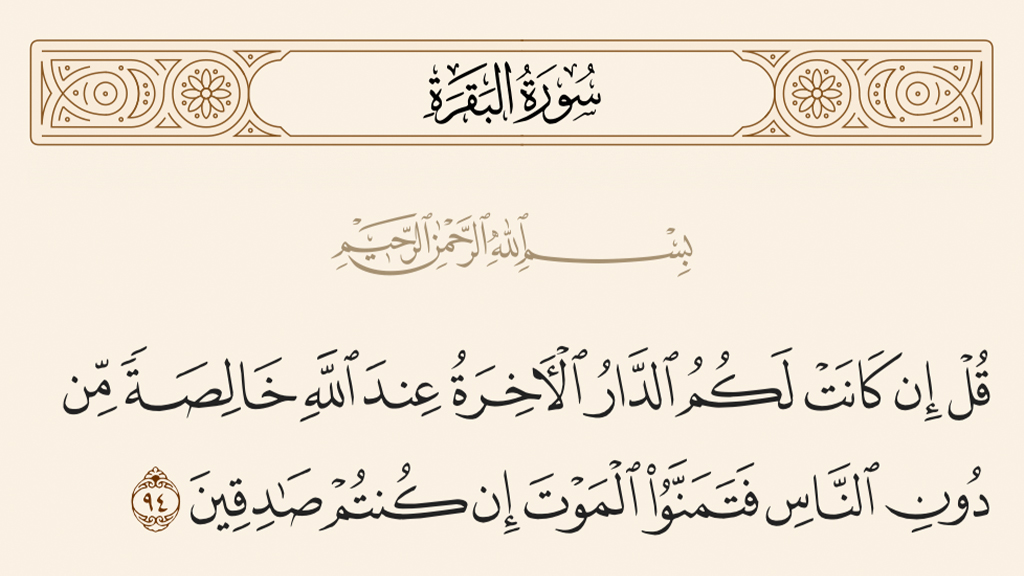
من عجائب التنبؤات القرآنية
-

فاطم حلّ نورها
-

محاضرة في مجلس الزّهراء للدّكتور عباس العمران حول طبّ الأطفال حديثي الولادة
-

تسبيحة السيدة الزهراء (ع)
-

المثل الأعلى وسيادة النموذج بين التفاعل والانفعال الزهراء (ع) أنموذجًا (3)
-
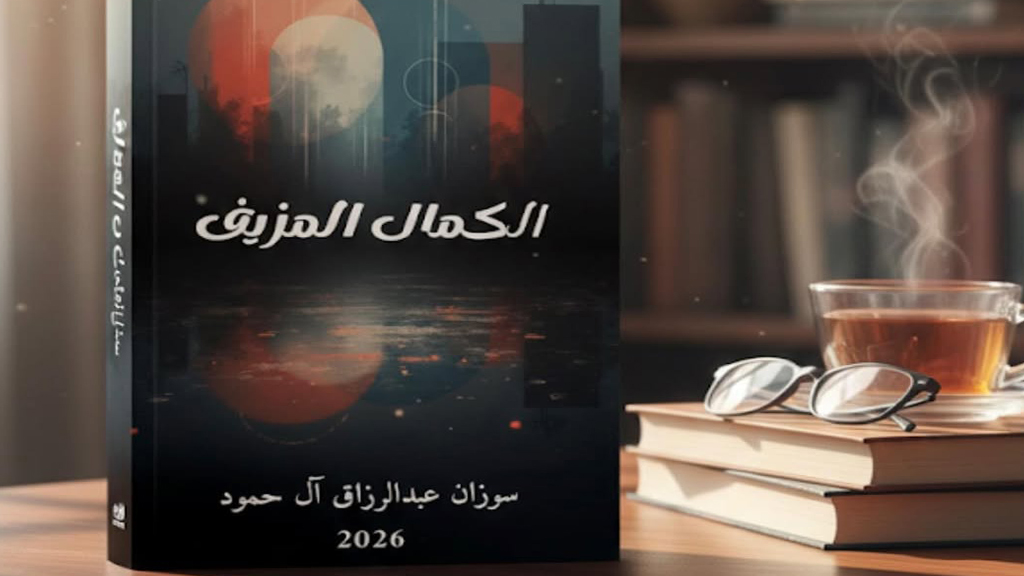
(الكمال المزيّف) جديد الكاتبة سوزان آل حمود
-

لـمّا استراح النّدى
-
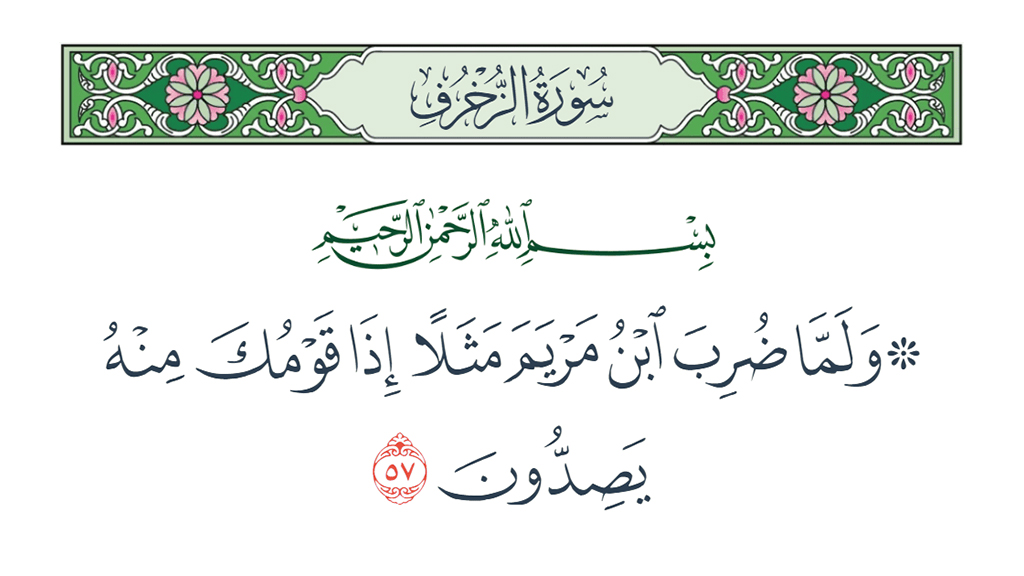
شتّان بين المؤمن والكافر